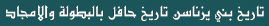مؤلفات الاستاذ محمد ستي:



عين واولّوت بين الأسطورة و الحقيقة:
بقلم محمد ستي
عين تبعد عن مدينة بركان في اتجاه الجنوب بثلاث كيلومترات، متاخمة لجبال بني يزناسن، عرفت توافد المستعمر الذي جعل منها قلعة عسكرية استرايجية، لبسط نفوذه و تأمين سيطرته على باقي المنطقة، و مراقبة الجوار لحماية مصالحه الاقتصادية، اعتبرها مصدرا أساسيا للري لما تزخر به من مياه باطنية تتفجر بين حين و آخر، لتتجمع على شكل بحيرة دائمة الجريان، تنساب بين أودية تُستغل في سقي المغروسات الفلاحية و الشرب الآدمي و الحيواني، مما جعلها محط اهتمام المستعمر الذي لم يكن اختياره للمنطقة جزافا، بل خطط و دبر باستراتيجية محكمة لاستنزاف خيراتها، فكانت عين واولوت ضمن هذاالمخطط الاستغلالي لتنمية مجاله الفلاحي، و إنعاش منتوجه بتطوير آليات الري، و مد الأراضي المجاورة للعين بقنوات سقي المزروعات خاصة الكروم و خضروات تسويقية.
لتوسيع أطماعه الاستنزافية فقد سخر خبثه الاستعماري في استغلال سذاجة أهل المنطقة، و محدودية فكرهم الذي لا يتعدى توفير قوتهم اليومي، بأن قام بترويج أساطير و روايات عما يظهر في العين الذي يأخذ شكل حوت ضخم أطلقوا عليه إسم" مسعود"، يلتهم كل من تجرأ على الاقتراب من البحيرة أو الاعتداء على مياهها، فنسجوا في حقه الكثير من القصص و الروايات عن غرق العديد ممن تجرأوا على الاقتراب من مملكته الغارقة تحت الماء، فتمكنوا من إرساء معتقدات استبدت بالعقول، و لفَّفَتها بخرافات صدقت بها و سعت من خلالها إلى إرضاء رغباته بطلبات تُخمد ثوراته الانتقامية، فجعلوها ذبائح لها مواصفات خاصة، هي وحدها ما قد تهدأ من روعه، لذلك فالدجاج الذي يذبخ فجرا عند رأس العين حيث مملكة" مسعود" يكون سبيلا لتهدئته بعد إلقائه في غمرته، لكنه في حقيقة الأمر لم يكن سوى تهدئة لبطون المستعمر الجائعة، الذي كان جنوده يتسحبون إلى العين مباشرة بعد مغادرة أهلها، لجمع الذبائح المتناثرة فوق المياه و جعلها لقمة سائغة تسد الرمق في انتظار ما ستجود به باقي الأيام المقبلة.
معتقدات استعمارية ذو حدين، القصد منها تخويف أهل المنطقة من استغلال مياه العين التي يحرسها" مسعود"، لتكون تحت تدبيره فقط دون أن يشاركه في ذلك أحد حتى لا تنضب فتتعرض مصالحه الفلاحية للإتلاف، و لم تقف أطماعه الاستنزافية عند هذا الحد، بل طالت المنتوجات المعيشية لأهل المنطقة من الدواجن و المواشي لنهبها بطرق ملتوية ماكرة، بترويج الخرافة و ممارسة طقوس مبتدعة تَقيهم بطش" مسعود"، فتُقدَّم له القرابين لاتقاء شره الذي يقابله في حقيقة الأمر شر و تنكيل المستعمر، و كل متمرد ثار على الخرافة التي صنعها بحرفية و إتقان، يساق إلى ضيعاتهم للعمل بالمجان على أن يودع السجن إذا لزم الأمر ذلك حسب سلطتهم التقديرية، يساعدهم في ترويج هذه المعتقدات و نفث سمومها مصلحيون خونة يسترزقون من سذاجة أهل المنطقة، ليمتصوا خيراتهم فيقدمونها لمن لا يستحقها، و لما عشَّشت الخرافة في العقول، هامت بالفكر إلى ابتداع سلوكات اعتقادية بكرامات " مسعود"، و خوارقه في شفاء الأمراض المستعصية، فصار كل مستضعف يقصد العين يتبرك ببركته فجرا كما اعتادوا عليها أيام الاستعمار، ليستمر هذا الطقس لأجيال متعاقبة، و استزادوه بدعا أخرى مقترنة بتقديم القرابين طلبا للشفاء و قضاء الحوائج و ليس لاتقاء شر" مسعود" كما كان في السابق، و لما كانت الخرافة لصيقة بالمستعمر و أصحاب المصالح و النفوذ فقد كرسوها و أنبتوها لتتجدر أكثر من أجل الحفاظ على مكانتهم داخل العشيرة، فالمعتقدات الخرافية لم تكن وليدة لحظة و ينقضي أثرها التدميري، بل لها امتداد تاريخي ضارب في القدم، مما جعل النفوس مهيئة للإعتقاد و التصديق بها كما حدث مع عين واولوت، التي نُسجت في حقها الكثير من الأساطير القديمة التي أثثت الموروث الثقافي للمنطقة، و تداولها العديد من المهتمين بالدراسة، و النبش في الذاكرة الشعبية لاستنباط الخفي منها و استقرائه وفق ضوابط يتقبلها العقل و الدين، و لما كانت جبال بني يزناسن محجا لمتصوفة فارين من بطش حكامهم لممارسة خلوتهم بين أدغالها الوعرة، و استقطاب مريدين لهم يستقوون بهم، فقد كان لأسطورة عين واولوت ارتباطا بكراماتهم، حسبما تواترته الروايات الشفوية عن عجوز عمياء سكنت مكانا و عشيرتها قبل أن يتحول إلى بحيرة مائية، و قد اختلفت مسمياتها بين" تاميمونت" و" لالة واولوت"، كانت تعيش بما تجود به معزتها من حليب و مشتقاته، تٌقاسمها الخيمة كلبة بجرائها، تَصادف يوم أن طرق بابها ضيف أو ثلاث حسب اختلاف الروايات، و طلبوا استضافتها لهم فلبت النداء، و أكرمت وفادتهم بمعزتها التي هي مصدر قوتها، و لما انبلج الصبح طلب منها أحدهم استحضار جلد المعزة فتمسح به لتعود إليها الحياة من جديد، كما حوَّل حشيشها و هي تطحنه إلى دقيق تكاثر حتى ملأ الخيمة، و دعاها إلى إخبار عشيرتها بترقب الكلبة أينما حلت بجرائها فثم مستقرهم الجديد، فلبى الكثيرون نداءها و تبعوا الجراء و أمهم إلى سدرة كثيفة، و في لحظة هبت عاصفة هوجاء مصحوبة بأمطار قوية حولت المكان إلى طوفان أغرقت كل من تعجرف و أبى اللحاق بعشيرته، فكان أن تحول ذلك المكان إلى عين تتدفق منها المياه دون انقطاع و سموها" عين واولوت"، و يقال أن الشخص صاحب الكرامات الذي أرجع للعجوز بصرها و أنقذها و عشيرتها من الغرق هو" عبد القادر الجيلالي"، الذي أقيم له ضريح في الجهة العليا المقابلة للعين، كما بنوا بجانب السدرة التي لمت العشيرة قبلا" مقاما" تجتمع فيه النسوة لممارسة الحضرة الصوفية و توزيع البركات على الزوار" الحرِّيف"، أسطورة كباقي الأساطير عند الإغريق و غيرهم ممن أبدعوا في نسج قصص بخيالهم الواسع، و براعتهم في التنقيب عما يسلب العقول و يستهويها، فكان للخوارق نصيب أوفر منها، مما يُترجم الخواء النفسي عند الإنسان و حاجته إلى ما يملأ به ذلك الفراغ الذي يستشعره، فكان لا بد أن يسعى إلى تصديق تلك الأساطير و البحث عن تجسيد لها على مستوى الواقع، لذلك كان للأضرحة و الروضات وجود احتاج إليه و ساهم في إنباته، ليمارس من أجله طقوسا ليست من الصوفية في شيء، فساد الاعتقاد بالخرافة و تقديس القبور و الأضرحة و المزارات، و ممارسة الشعوذة بتعليق التمائم و الأقمشة على فروع الأشجار المجاورة للضريح، و الطواف حوله تبركا به و استجداء لبركته، و بركة" مسعود" عند العين، في اعتقاد منهم أن هذه المزارات تتضمن سحرا خفيا بإمكانه قضاء الحاجات، لذلك باتت تحتل مكانة مهمة في الثقافة الشعبية التي أثثها أهل المنطقة بمعتقداتهم.
من هاته الأساطير استسقى المستعمر بدهائه قصة المملكة تحت الماء و ملكها" مسعود"، ليبسط نفوذه بتدمير العقول بالخرافة و الدجل و تقديس الأضرحة، لتكون عونا له على استنزاف ما تجود به الأرض من خيرات، لكن محدودية الفكر، و غياب المنطق في تحليل الظواهر الطبيعية من غيرها، جعلهم يرتمون بين براثن معتقدات خرافية كان لها أثر سلبي على الأجيال المتعاقبة التي لم يكن حظها أوفر من سابقاتها، بل كرست تلك الطقوس و أبدعت فيها إلى درجة جعلوا العروس إذا مرت بجوار ضريح" عبد المومن بوقبراين" و لو عن بعد تترجل عن حصانها، فيضعون فوق رأسها قبة من الحَلْفاء لتتابع طريقها مشيا حافية القدمين إلى غاية بيت الزوجية، توجسا من أن تصيبها لعنته إذا فعلت غير ذلك. معتقدات لها صيرورتها التاريخية و طالها الانحراف عن المسار الصحيح الذي جاء به المتصوفة لتنوير العقول، و تفتيقها على أشياء فيها من المنطق المتشبع بالدين، لكن لكل زمن رجالاته الذين تميزوا بالشجاعة في مواجهة المعتقدات الخرافية باستنادهم على ما اكتسبوه من علوم في الفقه و الحديث و التزموا بنشره، و منطقة" واولوت" لم تخلو من مثل هؤلاء الرجال، نخص بالذكر لا الحصر السيد" احمد الوشكرادي" الذي كرس حياته في محاربة الطقوس و التعاويذ، و السلوكات الخرافية التي تمارس حول العين و بجانب الضريح، و لم يتوانى لحظة في التخلي عن مشروعه الدعوي، لتصحيح المفاهيم و تنوير العقول رغم ما جوبه به من جفاء و إقصاء لمخالفته العامة في معتقداتهم، و قد تمكن من تخفيف حدتها، دون أن يثني ذلك من عزمه، بل استمر على دربه إلى أن وافته المنية، أراد للجميع أن يدركوا أن عين" واولوت" التي يتبركون ببركاتها طلبا لقضاء حاجاتهم ليست كما يعتقدون، بل هي مجرد منبع مائي انفجر من باطن أرض متشبعة بمياه جوفية كباقي العيون المتناثرة بجبال بني يزناسن، و لا تستحق منهم كل ذلك التقديس، و نفس الشيء بالنسبة لما يمارس من شعوذة و دجل بضريح الولي، و كذلك التبرك بالأحجار و التمسح بالتراب و العويل عند الأولياء، سلوكات تعيد إنتاج الجاهلية لكن بصورة مختلفة عن سابقتها.
انحراف الصوفية عن مسارها أغرق المجتمعات في الخرافة من أجل الحفاظ على نفوذها و مصالحها، و الإبقاء على الرباط الذي يجمعها بمريديها، و تجاوزها يحتاج إلى زمن للمأسسة لفكر تنويري يجمع بين المنطق و الدين، وفق رؤية تحليلية مبنية على البحث و تقصي الحقائق و الاستفسار في شأنها.
بقلم محمد ستي
عين تبعد عن مدينة بركان في اتجاه الجنوب بثلاث كيلومترات، متاخمة لجبال بني يزناسن، عرفت توافد المستعمر الذي جعل منها قلعة عسكرية استرايجية، لبسط نفوذه و تأمين سيطرته على باقي المنطقة، و مراقبة الجوار لحماية مصالحه الاقتصادية، اعتبرها مصدرا أساسيا للري لما تزخر به من مياه باطنية تتفجر بين حين و آخر، لتتجمع على شكل بحيرة دائمة الجريان، تنساب بين أودية تُستغل في سقي المغروسات الفلاحية و الشرب الآدمي و الحيواني، مما جعلها محط اهتمام المستعمر الذي لم يكن اختياره للمنطقة جزافا، بل خطط و دبر باستراتيجية محكمة لاستنزاف خيراتها، فكانت عين واولوت ضمن هذاالمخطط الاستغلالي لتنمية مجاله الفلاحي، و إنعاش منتوجه بتطوير آليات الري، و مد الأراضي المجاورة للعين بقنوات سقي المزروعات خاصة الكروم و خضروات تسويقية.
لتوسيع أطماعه الاستنزافية فقد سخر خبثه الاستعماري في استغلال سذاجة أهل المنطقة، و محدودية فكرهم الذي لا يتعدى توفير قوتهم اليومي، بأن قام بترويج أساطير و روايات عما يظهر في العين الذي يأخذ شكل حوت ضخم أطلقوا عليه إسم" مسعود"، يلتهم كل من تجرأ على الاقتراب من البحيرة أو الاعتداء على مياهها، فنسجوا في حقه الكثير من القصص و الروايات عن غرق العديد ممن تجرأوا على الاقتراب من مملكته الغارقة تحت الماء، فتمكنوا من إرساء معتقدات استبدت بالعقول، و لفَّفَتها بخرافات صدقت بها و سعت من خلالها إلى إرضاء رغباته بطلبات تُخمد ثوراته الانتقامية، فجعلوها ذبائح لها مواصفات خاصة، هي وحدها ما قد تهدأ من روعه، لذلك فالدجاج الذي يذبخ فجرا عند رأس العين حيث مملكة" مسعود" يكون سبيلا لتهدئته بعد إلقائه في غمرته، لكنه في حقيقة الأمر لم يكن سوى تهدئة لبطون المستعمر الجائعة، الذي كان جنوده يتسحبون إلى العين مباشرة بعد مغادرة أهلها، لجمع الذبائح المتناثرة فوق المياه و جعلها لقمة سائغة تسد الرمق في انتظار ما ستجود به باقي الأيام المقبلة.
معتقدات استعمارية ذو حدين، القصد منها تخويف أهل المنطقة من استغلال مياه العين التي يحرسها" مسعود"، لتكون تحت تدبيره فقط دون أن يشاركه في ذلك أحد حتى لا تنضب فتتعرض مصالحه الفلاحية للإتلاف، و لم تقف أطماعه الاستنزافية عند هذا الحد، بل طالت المنتوجات المعيشية لأهل المنطقة من الدواجن و المواشي لنهبها بطرق ملتوية ماكرة، بترويج الخرافة و ممارسة طقوس مبتدعة تَقيهم بطش" مسعود"، فتُقدَّم له القرابين لاتقاء شره الذي يقابله في حقيقة الأمر شر و تنكيل المستعمر، و كل متمرد ثار على الخرافة التي صنعها بحرفية و إتقان، يساق إلى ضيعاتهم للعمل بالمجان على أن يودع السجن إذا لزم الأمر ذلك حسب سلطتهم التقديرية، يساعدهم في ترويج هذه المعتقدات و نفث سمومها مصلحيون خونة يسترزقون من سذاجة أهل المنطقة، ليمتصوا خيراتهم فيقدمونها لمن لا يستحقها، و لما عشَّشت الخرافة في العقول، هامت بالفكر إلى ابتداع سلوكات اعتقادية بكرامات " مسعود"، و خوارقه في شفاء الأمراض المستعصية، فصار كل مستضعف يقصد العين يتبرك ببركته فجرا كما اعتادوا عليها أيام الاستعمار، ليستمر هذا الطقس لأجيال متعاقبة، و استزادوه بدعا أخرى مقترنة بتقديم القرابين طلبا للشفاء و قضاء الحوائج و ليس لاتقاء شر" مسعود" كما كان في السابق، و لما كانت الخرافة لصيقة بالمستعمر و أصحاب المصالح و النفوذ فقد كرسوها و أنبتوها لتتجدر أكثر من أجل الحفاظ على مكانتهم داخل العشيرة، فالمعتقدات الخرافية لم تكن وليدة لحظة و ينقضي أثرها التدميري، بل لها امتداد تاريخي ضارب في القدم، مما جعل النفوس مهيئة للإعتقاد و التصديق بها كما حدث مع عين واولوت، التي نُسجت في حقها الكثير من الأساطير القديمة التي أثثت الموروث الثقافي للمنطقة، و تداولها العديد من المهتمين بالدراسة، و النبش في الذاكرة الشعبية لاستنباط الخفي منها و استقرائه وفق ضوابط يتقبلها العقل و الدين، و لما كانت جبال بني يزناسن محجا لمتصوفة فارين من بطش حكامهم لممارسة خلوتهم بين أدغالها الوعرة، و استقطاب مريدين لهم يستقوون بهم، فقد كان لأسطورة عين واولوت ارتباطا بكراماتهم، حسبما تواترته الروايات الشفوية عن عجوز عمياء سكنت مكانا و عشيرتها قبل أن يتحول إلى بحيرة مائية، و قد اختلفت مسمياتها بين" تاميمونت" و" لالة واولوت"، كانت تعيش بما تجود به معزتها من حليب و مشتقاته، تٌقاسمها الخيمة كلبة بجرائها، تَصادف يوم أن طرق بابها ضيف أو ثلاث حسب اختلاف الروايات، و طلبوا استضافتها لهم فلبت النداء، و أكرمت وفادتهم بمعزتها التي هي مصدر قوتها، و لما انبلج الصبح طلب منها أحدهم استحضار جلد المعزة فتمسح به لتعود إليها الحياة من جديد، كما حوَّل حشيشها و هي تطحنه إلى دقيق تكاثر حتى ملأ الخيمة، و دعاها إلى إخبار عشيرتها بترقب الكلبة أينما حلت بجرائها فثم مستقرهم الجديد، فلبى الكثيرون نداءها و تبعوا الجراء و أمهم إلى سدرة كثيفة، و في لحظة هبت عاصفة هوجاء مصحوبة بأمطار قوية حولت المكان إلى طوفان أغرقت كل من تعجرف و أبى اللحاق بعشيرته، فكان أن تحول ذلك المكان إلى عين تتدفق منها المياه دون انقطاع و سموها" عين واولوت"، و يقال أن الشخص صاحب الكرامات الذي أرجع للعجوز بصرها و أنقذها و عشيرتها من الغرق هو" عبد القادر الجيلالي"، الذي أقيم له ضريح في الجهة العليا المقابلة للعين، كما بنوا بجانب السدرة التي لمت العشيرة قبلا" مقاما" تجتمع فيه النسوة لممارسة الحضرة الصوفية و توزيع البركات على الزوار" الحرِّيف"، أسطورة كباقي الأساطير عند الإغريق و غيرهم ممن أبدعوا في نسج قصص بخيالهم الواسع، و براعتهم في التنقيب عما يسلب العقول و يستهويها، فكان للخوارق نصيب أوفر منها، مما يُترجم الخواء النفسي عند الإنسان و حاجته إلى ما يملأ به ذلك الفراغ الذي يستشعره، فكان لا بد أن يسعى إلى تصديق تلك الأساطير و البحث عن تجسيد لها على مستوى الواقع، لذلك كان للأضرحة و الروضات وجود احتاج إليه و ساهم في إنباته، ليمارس من أجله طقوسا ليست من الصوفية في شيء، فساد الاعتقاد بالخرافة و تقديس القبور و الأضرحة و المزارات، و ممارسة الشعوذة بتعليق التمائم و الأقمشة على فروع الأشجار المجاورة للضريح، و الطواف حوله تبركا به و استجداء لبركته، و بركة" مسعود" عند العين، في اعتقاد منهم أن هذه المزارات تتضمن سحرا خفيا بإمكانه قضاء الحاجات، لذلك باتت تحتل مكانة مهمة في الثقافة الشعبية التي أثثها أهل المنطقة بمعتقداتهم.
من هاته الأساطير استسقى المستعمر بدهائه قصة المملكة تحت الماء و ملكها" مسعود"، ليبسط نفوذه بتدمير العقول بالخرافة و الدجل و تقديس الأضرحة، لتكون عونا له على استنزاف ما تجود به الأرض من خيرات، لكن محدودية الفكر، و غياب المنطق في تحليل الظواهر الطبيعية من غيرها، جعلهم يرتمون بين براثن معتقدات خرافية كان لها أثر سلبي على الأجيال المتعاقبة التي لم يكن حظها أوفر من سابقاتها، بل كرست تلك الطقوس و أبدعت فيها إلى درجة جعلوا العروس إذا مرت بجوار ضريح" عبد المومن بوقبراين" و لو عن بعد تترجل عن حصانها، فيضعون فوق رأسها قبة من الحَلْفاء لتتابع طريقها مشيا حافية القدمين إلى غاية بيت الزوجية، توجسا من أن تصيبها لعنته إذا فعلت غير ذلك. معتقدات لها صيرورتها التاريخية و طالها الانحراف عن المسار الصحيح الذي جاء به المتصوفة لتنوير العقول، و تفتيقها على أشياء فيها من المنطق المتشبع بالدين، لكن لكل زمن رجالاته الذين تميزوا بالشجاعة في مواجهة المعتقدات الخرافية باستنادهم على ما اكتسبوه من علوم في الفقه و الحديث و التزموا بنشره، و منطقة" واولوت" لم تخلو من مثل هؤلاء الرجال، نخص بالذكر لا الحصر السيد" احمد الوشكرادي" الذي كرس حياته في محاربة الطقوس و التعاويذ، و السلوكات الخرافية التي تمارس حول العين و بجانب الضريح، و لم يتوانى لحظة في التخلي عن مشروعه الدعوي، لتصحيح المفاهيم و تنوير العقول رغم ما جوبه به من جفاء و إقصاء لمخالفته العامة في معتقداتهم، و قد تمكن من تخفيف حدتها، دون أن يثني ذلك من عزمه، بل استمر على دربه إلى أن وافته المنية، أراد للجميع أن يدركوا أن عين" واولوت" التي يتبركون ببركاتها طلبا لقضاء حاجاتهم ليست كما يعتقدون، بل هي مجرد منبع مائي انفجر من باطن أرض متشبعة بمياه جوفية كباقي العيون المتناثرة بجبال بني يزناسن، و لا تستحق منهم كل ذلك التقديس، و نفس الشيء بالنسبة لما يمارس من شعوذة و دجل بضريح الولي، و كذلك التبرك بالأحجار و التمسح بالتراب و العويل عند الأولياء، سلوكات تعيد إنتاج الجاهلية لكن بصورة مختلفة عن سابقتها.
انحراف الصوفية عن مسارها أغرق المجتمعات في الخرافة من أجل الحفاظ على نفوذها و مصالحها، و الإبقاء على الرباط الذي يجمعها بمريديها، و تجاوزها يحتاج إلى زمن للمأسسة لفكر تنويري يجمع بين المنطق و الدين، وفق رؤية تحليلية مبنية على البحث و تقصي الحقائق و الاستفسار في شأنها.

أطلال شاهدة على قيم لم تُدرس:
بقلم محمد ستي
منازل تهدمت بعد أن هجرها أصحابها، فتحولت إلى أطلال منسية تكومت أحجارها، لتوحي لنا بعدم جدواها بعد أن كانت مرصوصة بنيانها، كمعمريها من أناس عاشوا الألفة و الترابط العائلي، يلفهم حنان يسع الجميع رغم تعددهم، فتجدهم يتوزعون في أداء مهامهم اليومية بتلقائية، لتوفير ظروف ملائمة للعيش، فالواحد منهم يسوق الأغنام لترعى كلأ و عشبا، و الآخر يلتحق بأعمال الزراعة، بينما يتكلف الصغار و النسوة بجلب المياه و القيام بأشغال البيت، و أحيانا يخرجن إلى مساعدة أزواجهن دون تذمر، و في الليل يتسامرون حول ما يخفف عنهم عناء النهار، و كان الكل ينتشي قوة و صحة بدنية، يتحمل على إثرها قسوة العيش و الطبيعة المتوحشة التي تحيط به، و في هذا التدبير العائلي المحكم تجد له زعيما يكون من بين أكبر الإخوة، يعودون إليه عند احتياجهم للمشورة أو النصح في أدق الأشياء، لحنكته و تجربته العريقة في الحياة، و لا يأتمرون إلا بأمره مهما اختلفت الرغبات و الاختيارات، فهو محاط بقدسية منبعها الاحترام، لأنه المدبر و الضامن برجاحة عقله للإبقاء على تلاحم العائلة و العيش تحت كنف واحد.
فالمنازل التي تكومت أحجارها اليوم و انتهت صلاحيتها، تخفي بين ثناياها أسرارا يمكن سبرها و استنطاقها لتشهد على أقوام أرادوا أن يعلمونا كيف نعيش مجتمعا عائليا و في أحلك الظروف، و كيف نمارس العدل بتلقائية في توزيع الأدوار و المهام، فالجميع يشتغل و ينتج دون اتكالية، كما أرادونا أيضا أن نتعلم كيف نتعاون لمواجهة صعوبات الحياة، و كيف نحترم من يستحق الاحترام، و كيف نعتمد فكر و مشورة الزعيم العادل، و قوة أفراد العائلة الملتحمة، و كيف نعلم أبناءنا قيما تجعلهم متراصين بطيبتهم و أخلاقهم، و كيف نتحمل الشدائد من أجل غيرنا، و كيف نتعلم القناعة و اقتسام القليل مع الآخر، ألم يكونوا بكل بساطتهم ينعمون بالرضا في مجتمعهم المصغر الذي يسوده الاحساس بالآخر و تقبله بكل محبة صادقة، رغم ما كانت تتسم به ظروف الحياة بالوعورة و التعقيدات، ألم تكن تلك المنازل المتهدمة التي نمر عبرها و لا نعيرها اهتماما، قد أوت يوما أقواما جعلوا لنا من تقاليدهم و سلوكاتهم قيما نحتذي بها و نسعى إلى إنباتها و ترسيخ جذورها بيننا، إلا أن واقع الحال يجعلنا عاجزين عن لم أفراد أسرة فبالأحرى عائلة متسمة بالتعدد، ولنصدق القول عن أنفسنا أننا خسرنا كنزا لم نستطع الحفاظ عليه.
و لعل في قبائل بني يزناسن منازل لو نطقت أحجارها لشهدت على كفاح تلك الأقوام التي صنعت لنا ما لا نقدر على أن نضاهيه بغيره، فهل لنا القدرة على إنباته و الابقاء عليه؟
بقلم محمد ستي
منازل تهدمت بعد أن هجرها أصحابها، فتحولت إلى أطلال منسية تكومت أحجارها، لتوحي لنا بعدم جدواها بعد أن كانت مرصوصة بنيانها، كمعمريها من أناس عاشوا الألفة و الترابط العائلي، يلفهم حنان يسع الجميع رغم تعددهم، فتجدهم يتوزعون في أداء مهامهم اليومية بتلقائية، لتوفير ظروف ملائمة للعيش، فالواحد منهم يسوق الأغنام لترعى كلأ و عشبا، و الآخر يلتحق بأعمال الزراعة، بينما يتكلف الصغار و النسوة بجلب المياه و القيام بأشغال البيت، و أحيانا يخرجن إلى مساعدة أزواجهن دون تذمر، و في الليل يتسامرون حول ما يخفف عنهم عناء النهار، و كان الكل ينتشي قوة و صحة بدنية، يتحمل على إثرها قسوة العيش و الطبيعة المتوحشة التي تحيط به، و في هذا التدبير العائلي المحكم تجد له زعيما يكون من بين أكبر الإخوة، يعودون إليه عند احتياجهم للمشورة أو النصح في أدق الأشياء، لحنكته و تجربته العريقة في الحياة، و لا يأتمرون إلا بأمره مهما اختلفت الرغبات و الاختيارات، فهو محاط بقدسية منبعها الاحترام، لأنه المدبر و الضامن برجاحة عقله للإبقاء على تلاحم العائلة و العيش تحت كنف واحد.
فالمنازل التي تكومت أحجارها اليوم و انتهت صلاحيتها، تخفي بين ثناياها أسرارا يمكن سبرها و استنطاقها لتشهد على أقوام أرادوا أن يعلمونا كيف نعيش مجتمعا عائليا و في أحلك الظروف، و كيف نمارس العدل بتلقائية في توزيع الأدوار و المهام، فالجميع يشتغل و ينتج دون اتكالية، كما أرادونا أيضا أن نتعلم كيف نتعاون لمواجهة صعوبات الحياة، و كيف نحترم من يستحق الاحترام، و كيف نعتمد فكر و مشورة الزعيم العادل، و قوة أفراد العائلة الملتحمة، و كيف نعلم أبناءنا قيما تجعلهم متراصين بطيبتهم و أخلاقهم، و كيف نتحمل الشدائد من أجل غيرنا، و كيف نتعلم القناعة و اقتسام القليل مع الآخر، ألم يكونوا بكل بساطتهم ينعمون بالرضا في مجتمعهم المصغر الذي يسوده الاحساس بالآخر و تقبله بكل محبة صادقة، رغم ما كانت تتسم به ظروف الحياة بالوعورة و التعقيدات، ألم تكن تلك المنازل المتهدمة التي نمر عبرها و لا نعيرها اهتماما، قد أوت يوما أقواما جعلوا لنا من تقاليدهم و سلوكاتهم قيما نحتذي بها و نسعى إلى إنباتها و ترسيخ جذورها بيننا، إلا أن واقع الحال يجعلنا عاجزين عن لم أفراد أسرة فبالأحرى عائلة متسمة بالتعدد، ولنصدق القول عن أنفسنا أننا خسرنا كنزا لم نستطع الحفاظ عليه.
و لعل في قبائل بني يزناسن منازل لو نطقت أحجارها لشهدت على كفاح تلك الأقوام التي صنعت لنا ما لا نقدر على أن نضاهيه بغيره، فهل لنا القدرة على إنباته و الابقاء عليه؟

طقوس الختان عند قبائل بني يزناسن:
بقلم محمد ستي
ختان الذكور أو" الطهارة" تقليد أرسته بعض الديانات السماوية، و جعلت له طقوسا و عوائد يشترك فيها الجميع مع اختلاف في بعض الشعائر التي تميز كل منطقة عن أخرى، لكنها تتوحد في تمظهراتها العامة، فهي شعيرة ضاربة في القدم و ثابتة في شريعة اليهود، كما تعتبر من الأسس التي تنبني عليها عقيدتهم، و علامة تمنح صفة الإنتماء لديانتهم لتمييزهم عن باقي الشعوب، و قد أعطيت لها أهمية خاصة إذا علمنا أن عملية الختان تتم عندهم في اليوم السابع لميلاد الطفل و إن صادفت يوم السبت أو يوم الغفران، و وفقا لذلك فإن طقس الختان يعد لديهم أيضا حفل تسمية، الأمر الذي حملهم على إحاطته بهالة من التعظيم، و جعلوه أكثر قداسة و أرفع شأنا من تلك الأيام التي يمنع العمل فيها، حتى أن الطفل إذا مات قبل أن يكمل سبعة أيام من ميلاده فإنه يتم ختنه قبل دفنه، لأهمية هذه الشعيرة التي توصي بها جميع الأسفار القديمة، تميزا لجنسهم و إثباتا لأحقيتهم في كونهم الشعب الذي اختاره الله و اصطفاه، حتى اكتسبت قوة القانون عندهم، و قبل اليهود تعاطى المصريون بدورهم لشعيرة الختان، فقد أثبت الباحثون الأركيولوجيون من خلال نبشهم لحفريات و ثقافات ماضية، وجود رسوم على الجدار الداخلية للأضرحة تؤكد ممارستهم لهذه العملية، كما اعتمدها المسلمون أيضا اتباعا لسنة إبراهيم عليه السلام باعتبارها فطرة إنسانية أساسية، مارسها عرب الجاهلية كتقليد قبل مجيء الإسلام، و استحسنها لما وجد فيها من طهارة و نظافة، فقام بترسيخها و جعل منها طقسا دينيا وشرط وجوبٍ لاكتمال العقيدة، فهي سنَّة حميدة دأب عليها المسلمون و لم يذكر لها وصية في القرآن الكريم، و قد توارثتها الأجيال المتعاقبة و صبغتها بكثير من الطقوس المبتدعة التي منحتها طابعا شعبويا، من خلال التهييء للولائم و الأهازيج الاحتفالية و شراء الألبسة للمختون و الإعداد لليلة الحناء، على اعتبار أن هذا اليوم يعد فترة انتقالية تهيء فيها الطفل لاستقبال الرجولة الموعودة، لذلك فتعظيما لعملية الطهور و حفاظا على البعد التراثي الثقافي الذي تختص به كل منطقة، و نظرا لمكانة شهر رمضان الدينية فإن أغلب العائلات كانت تحرص على ختان أبنائها في نصفه أو في ليلة القدر أو في عيد المولد النبوي، كنوع من البركة التي قد تحل في هذه الأيام المقدسة، لكن مع توالي الحقب التاريخية حدثت الكثير من التغييرات التي طالت مجموعة من العوائد، التي ساقها الإنسان معه و حملها في مخزونه الثقافي، ليؤثث بها ذاكرته الشعبية التي طبعتها بطقوس و تقاليد مختلفة، يصنع منها احتفالا يليق بعظمة يوم الختان.
لقبائل بني يزناسن هي الأخرى عوائدها في ممارسة عملية الطهور التي أضحت جزءا من موروثها الاجتماعي الحافل بطقوس متجدرة تعكس تنوعها الثقافي، من حيث الإعداد لهذا اليوم من تحضير مسبق للحلويات المصنوعة من البيض بأشكال مختلفة، و مكسرات متنوعة حسب المتوفر في السوق، و كل ما تجود به البادية من زبدة و عسل و" زميطة" من أجل إكرام الضيوف بهذه المستحضرات التي تكون مرفوقة بصينية الشاي التي تتوسط الجلسة و يتولاها كبير القبيلة، و لن تُرفع إلا عند الغداء أو العشاء على أن ترجع لتأخذ مكانها فتُأثث الجلسة، ليحلو معها السمر و الحكي عن تجارب و مغامرات تستهوي السمع، و تشجع الجميع على الانخراط في تنشيط المدعوين بمستملحات تخفف عنهم العبء اليومي، فهي جلسة تكتسي طابعا عائليا تشارك فيها الجدات بما تجُدن به من ذكريات خلت، تؤرخ لمرحلة بتحولاتها الطقوسية لحفل الختان و النوادر التي صاحبتها، و في ذات الوقت تكون باقي النسوة منهمكات في ترديد بعض الأذكار و الأمداح المرتبطة بالمناسبة، باعتبارها شعيرة دينية تقننها تعاليم تستوجب التقيد بها، بل يتم تخصيص ليلة يغلب عليها الطابع الديني، يحييها فقيه الدوار بمعية فقهاء آخرين، حيث يُتلى فيها القرآن الكريم، و تردد فيها الأذكار مع بعض الأدعية للمختون الذي يتموضع بحجر الفقيه، و هو يدعو له واضعا يده على رأسه لتحل عليه البركة و تعجل بشفائه. استكمالا لطقوس التحضير لاستقبال يوم الطهور بما يليق به كمرحلة فاصلة في حياة الصبي، تقوم الأم بشراء ألبسة تقليدية تتكون من طربوش و عباءة بيضاء و بلغة و لوازم أخرى للتزيين، تعظيما و فرحا بهذا اليوم الذي سينقل ابنها إلى مرحلة تهيؤه لمعانقة مستقبل زاهر ينتظره، تتم عملية اقتناء التجهيزات خفية عن الصبي، حتى لا يتملكه الخوف فيصبح حبيس شعور قد ينغص عليه راحته، و يبعده عن صفاء الروح الذي ينبغي أن يستقبل به يوم الطهور، كما تخفي الأم جميع متعلقات الطفل من مقتنيات عن أنظار المدعوين إلى أن يحل اليوم الموعود، خلال هذه الفترة من الإعدادات يعامل الطفل معاملة العرسان، حيث تُلبى له جميع الطلبات و يولونه اهتماما زائدا و حنانا فياضا، و لاينبغي أن يتعرض لمضايقات من أحد، لأنه يعيش مرحلة فاصلة و مقدسة في حياته.
في اليوم الذي يسبق يوم الإعذار يستحم الصبي لتقام حفلة الحناء وفق الطقوس المعمول بها، حيث توضع هذه الأخيرة في قصعة تتوسطها شمعة و بيضة طازجة، لتقوم الجدة أو إحدى العجائز بتحنية كفيه و رجليه، بينما المتبقى منها يعطى للقريبات العازبات علَّهن يظفرن بزواج في القريب العاجل، و كل ذلك يحدث وسط أغاني راقصة، و أذكار نبوية للحفاظ على صبغتها الدينية، و مستملحات تُذهب شبح الخوف الذي تستشعره الأم من جراء ما ينتظر ابنها، كما تقوم بعض النسوة بسرد مغامرات و تجارب الأجداد، و بعض النوادر حول ممارستهم لهذا الطقس، لما فيه من تقوية للعزائم و إذهاب للشعور بالخوف، بينما تتعالى الزغاريد و الأهازيج بين حين و آخر لتنكيه الأجواء بالفرح.
بعد التحضير ليوم الختان بكل ما يلزم للاحتفال به، تقوم الأم صباحا بإلباس عريسها الصغير ألبسته التقليدية من طربوش و سروال و عباءة بيضاء و بلغة، و هو ينتشي فرحا بها ببراءة فَطَر عليها دون أن يساوره إحساس بما ينتظره من ختن ذكره، كما تضع على رجله اليمنى خيطا به ما يسمى" بالودعة"، و هي عبارة عن" حلزون أبيض صلب" و" لوبانا يميل إلى الحمرة" و لفافة بها مواد مثل" الحرمل" و" الشب"، و تميمة، حسب المعتقدات الشعبية المبتدعة التي لم يكن لها وجودا عبر السيرورة التاريخية للمظاهر الاحتفالية بعملية الطهور، حيث امتزجت الشعوذة بالطقوس الدينية الصرفة، التي كان القصد منها إبعاد الضرر و نحس العين عن الصبي، و بعد إفراغ الأم مما كانت منهمكة فيه، تشد ابنها إلى جانبها و لا تفارقه إلا إذا أتى حجام القبيلة الذي يتميز بحرفية تامة اكتسبها بتجاربه العريقة في هذا الميدان، فهو يمارس مهنة الحلاقة إلى جانب ختان الأطفال، و قبل وصوله يتم استحضار قفة مملوءة بالتراب، و قصعة بها ماء تتوسطها بيضة طازجة و ديك بعرفه المتوج فوق رأسه، و عندما يحل الحجام و مساعدوه يسلمونه الطفل ببراءته و خلو ذهنه و صفاء سريرته، في هذه الأثناء تقوم الأم بجرح عرف الديك حتى يسيل دمه، لئلا يشعر الصبي بالألم حسب المعتقد الشعبي الرائج، ثم يتم ذبحه و طهيه ليشرب الطفل مرقه بعد ختانه ليعوض الدم الذي نزف منه، و بينما يكون بين يدي الحجام يضع مساعده حجابا بإزار يفصلهم عن العالم الخارجي، و لا يحق للمرأة أن تحضر عملية الختان، و كذلك الأمر بالنسبة للأب ليبقى الإحترام متكاملا بينهما، و الأم بدورها تتزين بما لديها من حلي، فتتوسط النساء واضعة رجلها اليمنى في قصعة مملوءة بقليل من الماء بداخلها بيضة طازجة، تعض بنواجدها" مسياسا من النقرة" في حرص منها أن تكمل هذا الطقس إلى نهايته بنجاح، و النسوة يُحِطن بها و أصواتهن تصدح بأغان و زغاريد على نغمات البندير حتى لا تتأذى الأم بصراخ الإبن، و في غمرة الأهازيج الاحتفالية تردد النسوة بفرحة عارمة غيوانا كلامه موجه إلى الحجام، ليستعجل الختان" الحجام خَفْ إيديك محمد بين إيديك"، في هذه الأثناء يكون الحجام قد أزال اللحمة الزائدة من على الحشفة، بعد أن طلب من المختون بطريقة إلهائية إجالة نظره نحو سقف البيت مرددا قوله" شوف الفار شوف الفار فالسطح"، فيقوم مساعده بتسليمه إلى إحدى القريبات العازبات لتضعه على ظهرها، فتحوم به حول أمه سبع مرات دون أن تنبس الأم ببنت شفة، ثم تحمله إلى فراشه المرتب سلفا، و لا تتحرك من مكانها و رجلها وسط القصعة إلا إذا هاداها زوجها بما يرضيها من نقود أو أشياء عينية، لتلتحق بجانب صبيها و لا تفارقه حتى يشفى، أما ماء القصعة فيوزع على الحاضرات للدهن طلبا للشفاء من الأمراض، بينما الجلدة المُزالة فتتولى إحدى العجائز دفنها في نفس المكان الذي أزيل منه تراب القفة، كما يُحتفظ بدم الختان في قماش ليصنع منه حجابا واقيا، أما خيط الطهور فيمنح للقريبات في رمزية إلى الحفاظ على شرفهن، في حين أن الطربوش تتمسح به العاقر طلبا للإنجاب، معتقدات مبتدعة غلبت عليها الشعوذة، و أفقدتها تلك الخاصية الدينية التي يقصد بها خروج الفرد من النجاسة إلى حالة النقاء لذلك سميت" بالطهارة".
بعد عملية إعذار الطفل تبدأ النقوط النقدية و ما شابه ذلك كنوع من التبريك، ينخرط فيها جميع الأهل و الجيران و الأصدقاء وسط أهازيج غنائية و زغاريد تطلق بين الفينة و الأخرى تكرما على الطفل و إفراحا له، كما يتم مهاداة أسرة المحتفى به بطقوس مختلفة و مثيرة، حيث تعلق النقود بعلم أبيض يُحمل في مسيرة تمتد إلى غاية منزل الصبي المختون على نغمات" العرفة" و زغاريد النسوة ليسلم إلى الأم.
طقوس متنوعة تختلف من عائلة إلى أخرى و من قبيلة إلى أخرى، لتشكل بهذا التنوع إرثا ثقافيا ذا بعد ديني و اجتماعي، ينضاف إلى الذاكرة الشعبية التي تحتفظ بالشيء الكثير، لتغني موروثا افتقد إلى من يجمعه و يعرِّف به.
بقلم محمد ستي
ختان الذكور أو" الطهارة" تقليد أرسته بعض الديانات السماوية، و جعلت له طقوسا و عوائد يشترك فيها الجميع مع اختلاف في بعض الشعائر التي تميز كل منطقة عن أخرى، لكنها تتوحد في تمظهراتها العامة، فهي شعيرة ضاربة في القدم و ثابتة في شريعة اليهود، كما تعتبر من الأسس التي تنبني عليها عقيدتهم، و علامة تمنح صفة الإنتماء لديانتهم لتمييزهم عن باقي الشعوب، و قد أعطيت لها أهمية خاصة إذا علمنا أن عملية الختان تتم عندهم في اليوم السابع لميلاد الطفل و إن صادفت يوم السبت أو يوم الغفران، و وفقا لذلك فإن طقس الختان يعد لديهم أيضا حفل تسمية، الأمر الذي حملهم على إحاطته بهالة من التعظيم، و جعلوه أكثر قداسة و أرفع شأنا من تلك الأيام التي يمنع العمل فيها، حتى أن الطفل إذا مات قبل أن يكمل سبعة أيام من ميلاده فإنه يتم ختنه قبل دفنه، لأهمية هذه الشعيرة التي توصي بها جميع الأسفار القديمة، تميزا لجنسهم و إثباتا لأحقيتهم في كونهم الشعب الذي اختاره الله و اصطفاه، حتى اكتسبت قوة القانون عندهم، و قبل اليهود تعاطى المصريون بدورهم لشعيرة الختان، فقد أثبت الباحثون الأركيولوجيون من خلال نبشهم لحفريات و ثقافات ماضية، وجود رسوم على الجدار الداخلية للأضرحة تؤكد ممارستهم لهذه العملية، كما اعتمدها المسلمون أيضا اتباعا لسنة إبراهيم عليه السلام باعتبارها فطرة إنسانية أساسية، مارسها عرب الجاهلية كتقليد قبل مجيء الإسلام، و استحسنها لما وجد فيها من طهارة و نظافة، فقام بترسيخها و جعل منها طقسا دينيا وشرط وجوبٍ لاكتمال العقيدة، فهي سنَّة حميدة دأب عليها المسلمون و لم يذكر لها وصية في القرآن الكريم، و قد توارثتها الأجيال المتعاقبة و صبغتها بكثير من الطقوس المبتدعة التي منحتها طابعا شعبويا، من خلال التهييء للولائم و الأهازيج الاحتفالية و شراء الألبسة للمختون و الإعداد لليلة الحناء، على اعتبار أن هذا اليوم يعد فترة انتقالية تهيء فيها الطفل لاستقبال الرجولة الموعودة، لذلك فتعظيما لعملية الطهور و حفاظا على البعد التراثي الثقافي الذي تختص به كل منطقة، و نظرا لمكانة شهر رمضان الدينية فإن أغلب العائلات كانت تحرص على ختان أبنائها في نصفه أو في ليلة القدر أو في عيد المولد النبوي، كنوع من البركة التي قد تحل في هذه الأيام المقدسة، لكن مع توالي الحقب التاريخية حدثت الكثير من التغييرات التي طالت مجموعة من العوائد، التي ساقها الإنسان معه و حملها في مخزونه الثقافي، ليؤثث بها ذاكرته الشعبية التي طبعتها بطقوس و تقاليد مختلفة، يصنع منها احتفالا يليق بعظمة يوم الختان.
لقبائل بني يزناسن هي الأخرى عوائدها في ممارسة عملية الطهور التي أضحت جزءا من موروثها الاجتماعي الحافل بطقوس متجدرة تعكس تنوعها الثقافي، من حيث الإعداد لهذا اليوم من تحضير مسبق للحلويات المصنوعة من البيض بأشكال مختلفة، و مكسرات متنوعة حسب المتوفر في السوق، و كل ما تجود به البادية من زبدة و عسل و" زميطة" من أجل إكرام الضيوف بهذه المستحضرات التي تكون مرفوقة بصينية الشاي التي تتوسط الجلسة و يتولاها كبير القبيلة، و لن تُرفع إلا عند الغداء أو العشاء على أن ترجع لتأخذ مكانها فتُأثث الجلسة، ليحلو معها السمر و الحكي عن تجارب و مغامرات تستهوي السمع، و تشجع الجميع على الانخراط في تنشيط المدعوين بمستملحات تخفف عنهم العبء اليومي، فهي جلسة تكتسي طابعا عائليا تشارك فيها الجدات بما تجُدن به من ذكريات خلت، تؤرخ لمرحلة بتحولاتها الطقوسية لحفل الختان و النوادر التي صاحبتها، و في ذات الوقت تكون باقي النسوة منهمكات في ترديد بعض الأذكار و الأمداح المرتبطة بالمناسبة، باعتبارها شعيرة دينية تقننها تعاليم تستوجب التقيد بها، بل يتم تخصيص ليلة يغلب عليها الطابع الديني، يحييها فقيه الدوار بمعية فقهاء آخرين، حيث يُتلى فيها القرآن الكريم، و تردد فيها الأذكار مع بعض الأدعية للمختون الذي يتموضع بحجر الفقيه، و هو يدعو له واضعا يده على رأسه لتحل عليه البركة و تعجل بشفائه. استكمالا لطقوس التحضير لاستقبال يوم الطهور بما يليق به كمرحلة فاصلة في حياة الصبي، تقوم الأم بشراء ألبسة تقليدية تتكون من طربوش و عباءة بيضاء و بلغة و لوازم أخرى للتزيين، تعظيما و فرحا بهذا اليوم الذي سينقل ابنها إلى مرحلة تهيؤه لمعانقة مستقبل زاهر ينتظره، تتم عملية اقتناء التجهيزات خفية عن الصبي، حتى لا يتملكه الخوف فيصبح حبيس شعور قد ينغص عليه راحته، و يبعده عن صفاء الروح الذي ينبغي أن يستقبل به يوم الطهور، كما تخفي الأم جميع متعلقات الطفل من مقتنيات عن أنظار المدعوين إلى أن يحل اليوم الموعود، خلال هذه الفترة من الإعدادات يعامل الطفل معاملة العرسان، حيث تُلبى له جميع الطلبات و يولونه اهتماما زائدا و حنانا فياضا، و لاينبغي أن يتعرض لمضايقات من أحد، لأنه يعيش مرحلة فاصلة و مقدسة في حياته.
في اليوم الذي يسبق يوم الإعذار يستحم الصبي لتقام حفلة الحناء وفق الطقوس المعمول بها، حيث توضع هذه الأخيرة في قصعة تتوسطها شمعة و بيضة طازجة، لتقوم الجدة أو إحدى العجائز بتحنية كفيه و رجليه، بينما المتبقى منها يعطى للقريبات العازبات علَّهن يظفرن بزواج في القريب العاجل، و كل ذلك يحدث وسط أغاني راقصة، و أذكار نبوية للحفاظ على صبغتها الدينية، و مستملحات تُذهب شبح الخوف الذي تستشعره الأم من جراء ما ينتظر ابنها، كما تقوم بعض النسوة بسرد مغامرات و تجارب الأجداد، و بعض النوادر حول ممارستهم لهذا الطقس، لما فيه من تقوية للعزائم و إذهاب للشعور بالخوف، بينما تتعالى الزغاريد و الأهازيج بين حين و آخر لتنكيه الأجواء بالفرح.
بعد التحضير ليوم الختان بكل ما يلزم للاحتفال به، تقوم الأم صباحا بإلباس عريسها الصغير ألبسته التقليدية من طربوش و سروال و عباءة بيضاء و بلغة، و هو ينتشي فرحا بها ببراءة فَطَر عليها دون أن يساوره إحساس بما ينتظره من ختن ذكره، كما تضع على رجله اليمنى خيطا به ما يسمى" بالودعة"، و هي عبارة عن" حلزون أبيض صلب" و" لوبانا يميل إلى الحمرة" و لفافة بها مواد مثل" الحرمل" و" الشب"، و تميمة، حسب المعتقدات الشعبية المبتدعة التي لم يكن لها وجودا عبر السيرورة التاريخية للمظاهر الاحتفالية بعملية الطهور، حيث امتزجت الشعوذة بالطقوس الدينية الصرفة، التي كان القصد منها إبعاد الضرر و نحس العين عن الصبي، و بعد إفراغ الأم مما كانت منهمكة فيه، تشد ابنها إلى جانبها و لا تفارقه إلا إذا أتى حجام القبيلة الذي يتميز بحرفية تامة اكتسبها بتجاربه العريقة في هذا الميدان، فهو يمارس مهنة الحلاقة إلى جانب ختان الأطفال، و قبل وصوله يتم استحضار قفة مملوءة بالتراب، و قصعة بها ماء تتوسطها بيضة طازجة و ديك بعرفه المتوج فوق رأسه، و عندما يحل الحجام و مساعدوه يسلمونه الطفل ببراءته و خلو ذهنه و صفاء سريرته، في هذه الأثناء تقوم الأم بجرح عرف الديك حتى يسيل دمه، لئلا يشعر الصبي بالألم حسب المعتقد الشعبي الرائج، ثم يتم ذبحه و طهيه ليشرب الطفل مرقه بعد ختانه ليعوض الدم الذي نزف منه، و بينما يكون بين يدي الحجام يضع مساعده حجابا بإزار يفصلهم عن العالم الخارجي، و لا يحق للمرأة أن تحضر عملية الختان، و كذلك الأمر بالنسبة للأب ليبقى الإحترام متكاملا بينهما، و الأم بدورها تتزين بما لديها من حلي، فتتوسط النساء واضعة رجلها اليمنى في قصعة مملوءة بقليل من الماء بداخلها بيضة طازجة، تعض بنواجدها" مسياسا من النقرة" في حرص منها أن تكمل هذا الطقس إلى نهايته بنجاح، و النسوة يُحِطن بها و أصواتهن تصدح بأغان و زغاريد على نغمات البندير حتى لا تتأذى الأم بصراخ الإبن، و في غمرة الأهازيج الاحتفالية تردد النسوة بفرحة عارمة غيوانا كلامه موجه إلى الحجام، ليستعجل الختان" الحجام خَفْ إيديك محمد بين إيديك"، في هذه الأثناء يكون الحجام قد أزال اللحمة الزائدة من على الحشفة، بعد أن طلب من المختون بطريقة إلهائية إجالة نظره نحو سقف البيت مرددا قوله" شوف الفار شوف الفار فالسطح"، فيقوم مساعده بتسليمه إلى إحدى القريبات العازبات لتضعه على ظهرها، فتحوم به حول أمه سبع مرات دون أن تنبس الأم ببنت شفة، ثم تحمله إلى فراشه المرتب سلفا، و لا تتحرك من مكانها و رجلها وسط القصعة إلا إذا هاداها زوجها بما يرضيها من نقود أو أشياء عينية، لتلتحق بجانب صبيها و لا تفارقه حتى يشفى، أما ماء القصعة فيوزع على الحاضرات للدهن طلبا للشفاء من الأمراض، بينما الجلدة المُزالة فتتولى إحدى العجائز دفنها في نفس المكان الذي أزيل منه تراب القفة، كما يُحتفظ بدم الختان في قماش ليصنع منه حجابا واقيا، أما خيط الطهور فيمنح للقريبات في رمزية إلى الحفاظ على شرفهن، في حين أن الطربوش تتمسح به العاقر طلبا للإنجاب، معتقدات مبتدعة غلبت عليها الشعوذة، و أفقدتها تلك الخاصية الدينية التي يقصد بها خروج الفرد من النجاسة إلى حالة النقاء لذلك سميت" بالطهارة".
بعد عملية إعذار الطفل تبدأ النقوط النقدية و ما شابه ذلك كنوع من التبريك، ينخرط فيها جميع الأهل و الجيران و الأصدقاء وسط أهازيج غنائية و زغاريد تطلق بين الفينة و الأخرى تكرما على الطفل و إفراحا له، كما يتم مهاداة أسرة المحتفى به بطقوس مختلفة و مثيرة، حيث تعلق النقود بعلم أبيض يُحمل في مسيرة تمتد إلى غاية منزل الصبي المختون على نغمات" العرفة" و زغاريد النسوة ليسلم إلى الأم.
طقوس متنوعة تختلف من عائلة إلى أخرى و من قبيلة إلى أخرى، لتشكل بهذا التنوع إرثا ثقافيا ذا بعد ديني و اجتماعي، ينضاف إلى الذاكرة الشعبية التي تحتفظ بالشيء الكثير، لتغني موروثا افتقد إلى من يجمعه و يعرِّف به.

زمن الجدَّات في الذاكرة لن يمحوه النسيان:
بقلم محمد ستي
الحديث عن الجدات يجرنا إلى تصور حياتهن القاسية بين أدغال الجبال الوعرة، التي تفتقر إلى شروط العيش المستقر و الهين، حياة تحتاج إلى أجسام قوية، و عقول حكيمة، و شحنات نفسية متميزة، تخلق لديهن الانسجام مع الظروف الصعبة، تسهل عليهن التعاطي مع متطلبات الحياة بروية و جلد، و التفاعل مع تقاليد القبيلة التي تحد من حريتهن، و تكبلهن بمجموعة من الأعراف التي لا ينبغي أن تتجافينها و تحِدن عنها لأي ذريعة كانت، مما يزيد من تعقيد أسباب الحياة لديهن و التعايش معها، لكن بسعة صدرهن و رجاحة عقلهن و صبرهن على تحمل الشدائد، جعلت منهن نساء قويات استطعن أن تتحكمن بدواليب الحياة التي وزعتهن بين أشغال البيت و متطلباته، و تربية الأولاد و ما تقتضيه من حكمة في التزاوج بينهما، و بين مشاركة الزوج في الأعمال الفلاحية، و تسويق المحصول المحلي، و تبضع الحاجيات الضرورية لضمان الأمن الغذائي لأفراد أسرهن ، فرغم كل الإكراهات التي جعلتهن تقاسين في حياتهن اليومية، فإنهن تمارسن أنشطة إضافية لمحاربة العوز و قلة الحيلة، فتجدهن تقمن بتربية الدواجن، و صناعة أغطية بالصوف" بورابح"، و أخرى بقطع من الأثواب القديمة" بوشراوط"، كما تشتغلن في الرعي و استغلال ما تنتجه الأبقار و الماعز من حليب و سمن، و العمل على تحويل" المرمز" من الشعير إلى" زميطة" للإستهلاك العائلي و البيع، و تربية النحل للحصول على عسل يكفيهم خلال السنة، و أحيانا تشتركن في أعمال أخرى لدى الجيران من تصبين الملابس، أو حلب الأبقار، و تجميع المياه لتلبية حاجيات الأسرة، و جلب حطب الوقود من مسافات بعيدة، كل ذلك من أجل رفاه أسرهن حتى لا يتلبسها الشعور بالحاجة و سؤال الآخرين، فرغم الظروف القاسية التي تكبدنها من أجل توفير عيش مستقر لأبنائهن، فإنهن لم تنشغلن عنهم بمعاناتهن اليومية، بل تحتضنَّهم و تمدَّنهم بالدفء و الحنان، و تُشرِّبنهم قيما خلوقة لتجعلن منهم عزوة وقت الشدائد، إنه عالم الجدات الذي ترك إرثا يستحق الاهتمام و النبش فيه لاستخلاص العبر.
لذلك فقد تصادفنا أحيانا مواقف تستفز ذاكرتنا، فتجعلنا نستعيد أشرطة تحكي عن ماض كنا أحد صانعيه ببراءة طفولتنا، فنستحضر منها ما كان موشوما في أعماقنا، من أطياف صور لحياة عشناها بكل تفاصيلها، حتى تركت بصماتها منقوشة في ذاكرتنا التي تأبى النسيان، و لم يكن من بد غير ترجمتها إلى حروف و كلمات تليق بها، و لعل ذلك يتطلب منا التغلغل أكثر في المخزون الوافر بذاكرتنا، لتستوقفنا فيه تلك الذكريات التي عشنا فصولها بالبيت الكبير، الذي تشهد جدرانه على ما لمَّ بينها من أفراد عائلة كانت تربطهم أواصر محبة صادقة، تقاسموها فيما بينهم بقلب نقي و غير متكدر، حتى أن ابتسامتهم لم تكن تفارق محياهم، ليوزعوها بين الكبير و الصغير، فالكل تغمره نشوة و رضا و هو يتوسط المجلس بين الأحباب في حضرة الجد الذي يسع قلبه الجميع، فتراه يحادث الكبار أحيانا و يلاعب الصغار أحيانا أخرى، و حتى إذا جنى الليل و انبعث السكون من ظلمته، افترشت النساء البيوت بما توفر من حصير و لحاف و غطاء صوفي يسمى" بورابح"، و آخر يسمى" بوشراوط" يلتحفه الجميع، و يشتركون دفأه و هم على جنب بعضهم يتسامرون و يستمتعون بمستملحات يرويها أحدهم إلى أن تأخذهم غفوة النوم.
و نحن صغار إذ كنا نتسابق إلى من يتوسد فخد الجدة، التي كانت تتحفنا بما لديها من أحاج(امقيدش، و ثامزا ووو) و ألغاز لا زالت عالقة في أذهاننا، و كان إذا استبد النوم بأحدنا جعلوا له مكانا بجانب الأطفال الذين صاروا نياما، و تستمر الجدة في سرد ما لديها في مخزونها من حكايات تمتع السمع و ترهف الحس لتفننها في طريقة الحكي، فنستمع إليها بشغف و نطالبها بالمزيد، و هي في ذلك غير متذمرة، بل تراها توزع حنانها بين أحفادها بكل رضا و أريحية، و يشاركها أحيانا بعض النسوة في تبادل الألغاز و البحث عن حلول لها، و نحن في غمرة هذا السجال إذ نتدافع حول من يأتيه الدور لينال شرف توسد فخد الجدة، لتهرش فرو رأسه بأناملها الحنونة و هي تردد ترانيم و أدعية، و إذا أطبق النوم جفوننا صرنا إلى أماكننا بين الأطفال نفترش فراشا و غطاء واحدا نتشاركه جميعا، و عند انبلاج الصبح نستفيق على رائحة الشاي المنعنع، و الفطير المصنوع بالشعير" راخصاص"، و كل ما جادت به البادية من منتوجاتها من عسل و سمن و حليب، أما الجدة بعد أن تنهي ما في عهدتها من أشغال تجدها تتسحب إلى غرفتنا، فتهمس في أذن هذا ثم تعاود الآخر إلى أن توقظنا جميعا لنشاركهم فطور الصباح، و لعل ما ميز ذلك التقاسم في كل خاصتنا ليشمل تشاركنا لفراش و غطاء واحد، هو ذلك التلاحم الذي استشعرناه في طفولتنا فولد لدينا انسجاما و تلاقيا في المشاعر و الأفكار، نتيجة ما تشربناه من تقاليد في بيت الأجداد، و إذ نتحدث عن هذا الماضي الجميل نتمنى أن يعاودنا ما افتقدناه فيه بفقدان من كان يلمنا في البيت الكبير الذي تحول إلى أطلال بتنا نتباكاه كلما تذكرنا أنه كان لنا فيه ذكريات خلت.
و تبقى الجدة مثالا للمرأة اليزناسنية التي أعطت الشيئ الكثير من أجل الإبقاء على تلاحم أفراد عائلتها، و قد كانت العفوية و الطيبة و المحبة من السمات التي طبعت شخصيتها، فجعلتها قريبة من قلوب الجميع، و لها من العطف و الحنان ما كانت توزعه على الكبير و الصغير، حتى إذا صرت إليها و أنت في حالة من الضجر و التكدر بسبب تعقيدات الحياة، هونت عليك بكلمات تجعلك تنتشي نشاطا يغير من حالتك المكتئبة، أما إذا استشعر أحد أفرادها مرضا فإنها تستزيد من اهتمامها و عنايتها به، و لن يغمض لها جفن إلا إذا تحسنت حاله، و هي في كل هذا تقدم خدماتها بالبيت دون أن تشعر أحدا بانشغالها عنه، فمثل هذا النموذج للمرأة ذات القلب الكبير و العقل المدبر تحتاج منا كل التقدير و الاحترام، باعتبارها مدرسة فريدة منطلقها العفوية و الطيبة و المحبة الصادقة.
نحِنُّ إلى زمن كانت فيه البوادي تنتج كل ما هو طبيعي كأساس لعيش أهلها اليومي، من زبدة و خبز شعير و زيت زيتون، حيث بهم كان يكرم الضيف، و يتداوى المريض لخلوهم مما يفسد نقاءهم الطبيعي، فالنفر منا كان ينتظر العطلة ليفر من صخب المدينة إلى البادية حيث الصفاء و الهدوء، و الجلوس إلى الجدة ورأسك على فخدها لتروي لك قصصا تهيم بخيالك إلى أبعد حدود الممكن، و أنت في ذلك تتشرب من قيم أصيلة فيها من تهذيب السلوك و تخليقها ما يصقل شخصيتك و يجعلها قوية و متحملة للشدائد، و أنت بين أطراف البادية المترامية ينتابك عشق إلى ركوب الدواب لجلب حاجة العائلة من الماء صحبة الجد الذي لا يكف بدوره عن سرد قصص و مغامرات تشدك إلى سماعها فتنتابك رغبة بطلب المزيد منها، حتى أنك لا تشعر ببعد المسافة الفاصلة بين البيت و العين مصدر الماء الزلال، و بعد العودة ينهمك الجد في أشغال الفلاحة ليوفر لعياله القوت الصحي و الطبيعي، الذي يسقى بمياه الأمطار الممزوجة بعرق جبينه، بينما الجدة تعد الطعام بعد إفراغها من طهي الخبز اللذيذ و الخالي من الزوائد الكيماوية، إنها البادية و ما بها لا يوصف في كلمات و سطور، و الحنين إلى من عمروها قبلا و افتقدناهم لن تجد لهم تعويضا، لأن عالمهم الذي صنعوه بعادات و تقاليد تجمعت لتشكل ثقافة لها أسرارها و أبعادها، ترغم الأبناء و الحفدة على البحث في كنهها و التعريف بها لتبقى خالدة تتشرب بها الأجيال.
بقلم محمد ستي
الحديث عن الجدات يجرنا إلى تصور حياتهن القاسية بين أدغال الجبال الوعرة، التي تفتقر إلى شروط العيش المستقر و الهين، حياة تحتاج إلى أجسام قوية، و عقول حكيمة، و شحنات نفسية متميزة، تخلق لديهن الانسجام مع الظروف الصعبة، تسهل عليهن التعاطي مع متطلبات الحياة بروية و جلد، و التفاعل مع تقاليد القبيلة التي تحد من حريتهن، و تكبلهن بمجموعة من الأعراف التي لا ينبغي أن تتجافينها و تحِدن عنها لأي ذريعة كانت، مما يزيد من تعقيد أسباب الحياة لديهن و التعايش معها، لكن بسعة صدرهن و رجاحة عقلهن و صبرهن على تحمل الشدائد، جعلت منهن نساء قويات استطعن أن تتحكمن بدواليب الحياة التي وزعتهن بين أشغال البيت و متطلباته، و تربية الأولاد و ما تقتضيه من حكمة في التزاوج بينهما، و بين مشاركة الزوج في الأعمال الفلاحية، و تسويق المحصول المحلي، و تبضع الحاجيات الضرورية لضمان الأمن الغذائي لأفراد أسرهن ، فرغم كل الإكراهات التي جعلتهن تقاسين في حياتهن اليومية، فإنهن تمارسن أنشطة إضافية لمحاربة العوز و قلة الحيلة، فتجدهن تقمن بتربية الدواجن، و صناعة أغطية بالصوف" بورابح"، و أخرى بقطع من الأثواب القديمة" بوشراوط"، كما تشتغلن في الرعي و استغلال ما تنتجه الأبقار و الماعز من حليب و سمن، و العمل على تحويل" المرمز" من الشعير إلى" زميطة" للإستهلاك العائلي و البيع، و تربية النحل للحصول على عسل يكفيهم خلال السنة، و أحيانا تشتركن في أعمال أخرى لدى الجيران من تصبين الملابس، أو حلب الأبقار، و تجميع المياه لتلبية حاجيات الأسرة، و جلب حطب الوقود من مسافات بعيدة، كل ذلك من أجل رفاه أسرهن حتى لا يتلبسها الشعور بالحاجة و سؤال الآخرين، فرغم الظروف القاسية التي تكبدنها من أجل توفير عيش مستقر لأبنائهن، فإنهن لم تنشغلن عنهم بمعاناتهن اليومية، بل تحتضنَّهم و تمدَّنهم بالدفء و الحنان، و تُشرِّبنهم قيما خلوقة لتجعلن منهم عزوة وقت الشدائد، إنه عالم الجدات الذي ترك إرثا يستحق الاهتمام و النبش فيه لاستخلاص العبر.
لذلك فقد تصادفنا أحيانا مواقف تستفز ذاكرتنا، فتجعلنا نستعيد أشرطة تحكي عن ماض كنا أحد صانعيه ببراءة طفولتنا، فنستحضر منها ما كان موشوما في أعماقنا، من أطياف صور لحياة عشناها بكل تفاصيلها، حتى تركت بصماتها منقوشة في ذاكرتنا التي تأبى النسيان، و لم يكن من بد غير ترجمتها إلى حروف و كلمات تليق بها، و لعل ذلك يتطلب منا التغلغل أكثر في المخزون الوافر بذاكرتنا، لتستوقفنا فيه تلك الذكريات التي عشنا فصولها بالبيت الكبير، الذي تشهد جدرانه على ما لمَّ بينها من أفراد عائلة كانت تربطهم أواصر محبة صادقة، تقاسموها فيما بينهم بقلب نقي و غير متكدر، حتى أن ابتسامتهم لم تكن تفارق محياهم، ليوزعوها بين الكبير و الصغير، فالكل تغمره نشوة و رضا و هو يتوسط المجلس بين الأحباب في حضرة الجد الذي يسع قلبه الجميع، فتراه يحادث الكبار أحيانا و يلاعب الصغار أحيانا أخرى، و حتى إذا جنى الليل و انبعث السكون من ظلمته، افترشت النساء البيوت بما توفر من حصير و لحاف و غطاء صوفي يسمى" بورابح"، و آخر يسمى" بوشراوط" يلتحفه الجميع، و يشتركون دفأه و هم على جنب بعضهم يتسامرون و يستمتعون بمستملحات يرويها أحدهم إلى أن تأخذهم غفوة النوم.
و نحن صغار إذ كنا نتسابق إلى من يتوسد فخد الجدة، التي كانت تتحفنا بما لديها من أحاج(امقيدش، و ثامزا ووو) و ألغاز لا زالت عالقة في أذهاننا، و كان إذا استبد النوم بأحدنا جعلوا له مكانا بجانب الأطفال الذين صاروا نياما، و تستمر الجدة في سرد ما لديها في مخزونها من حكايات تمتع السمع و ترهف الحس لتفننها في طريقة الحكي، فنستمع إليها بشغف و نطالبها بالمزيد، و هي في ذلك غير متذمرة، بل تراها توزع حنانها بين أحفادها بكل رضا و أريحية، و يشاركها أحيانا بعض النسوة في تبادل الألغاز و البحث عن حلول لها، و نحن في غمرة هذا السجال إذ نتدافع حول من يأتيه الدور لينال شرف توسد فخد الجدة، لتهرش فرو رأسه بأناملها الحنونة و هي تردد ترانيم و أدعية، و إذا أطبق النوم جفوننا صرنا إلى أماكننا بين الأطفال نفترش فراشا و غطاء واحدا نتشاركه جميعا، و عند انبلاج الصبح نستفيق على رائحة الشاي المنعنع، و الفطير المصنوع بالشعير" راخصاص"، و كل ما جادت به البادية من منتوجاتها من عسل و سمن و حليب، أما الجدة بعد أن تنهي ما في عهدتها من أشغال تجدها تتسحب إلى غرفتنا، فتهمس في أذن هذا ثم تعاود الآخر إلى أن توقظنا جميعا لنشاركهم فطور الصباح، و لعل ما ميز ذلك التقاسم في كل خاصتنا ليشمل تشاركنا لفراش و غطاء واحد، هو ذلك التلاحم الذي استشعرناه في طفولتنا فولد لدينا انسجاما و تلاقيا في المشاعر و الأفكار، نتيجة ما تشربناه من تقاليد في بيت الأجداد، و إذ نتحدث عن هذا الماضي الجميل نتمنى أن يعاودنا ما افتقدناه فيه بفقدان من كان يلمنا في البيت الكبير الذي تحول إلى أطلال بتنا نتباكاه كلما تذكرنا أنه كان لنا فيه ذكريات خلت.
و تبقى الجدة مثالا للمرأة اليزناسنية التي أعطت الشيئ الكثير من أجل الإبقاء على تلاحم أفراد عائلتها، و قد كانت العفوية و الطيبة و المحبة من السمات التي طبعت شخصيتها، فجعلتها قريبة من قلوب الجميع، و لها من العطف و الحنان ما كانت توزعه على الكبير و الصغير، حتى إذا صرت إليها و أنت في حالة من الضجر و التكدر بسبب تعقيدات الحياة، هونت عليك بكلمات تجعلك تنتشي نشاطا يغير من حالتك المكتئبة، أما إذا استشعر أحد أفرادها مرضا فإنها تستزيد من اهتمامها و عنايتها به، و لن يغمض لها جفن إلا إذا تحسنت حاله، و هي في كل هذا تقدم خدماتها بالبيت دون أن تشعر أحدا بانشغالها عنه، فمثل هذا النموذج للمرأة ذات القلب الكبير و العقل المدبر تحتاج منا كل التقدير و الاحترام، باعتبارها مدرسة فريدة منطلقها العفوية و الطيبة و المحبة الصادقة.
نحِنُّ إلى زمن كانت فيه البوادي تنتج كل ما هو طبيعي كأساس لعيش أهلها اليومي، من زبدة و خبز شعير و زيت زيتون، حيث بهم كان يكرم الضيف، و يتداوى المريض لخلوهم مما يفسد نقاءهم الطبيعي، فالنفر منا كان ينتظر العطلة ليفر من صخب المدينة إلى البادية حيث الصفاء و الهدوء، و الجلوس إلى الجدة ورأسك على فخدها لتروي لك قصصا تهيم بخيالك إلى أبعد حدود الممكن، و أنت في ذلك تتشرب من قيم أصيلة فيها من تهذيب السلوك و تخليقها ما يصقل شخصيتك و يجعلها قوية و متحملة للشدائد، و أنت بين أطراف البادية المترامية ينتابك عشق إلى ركوب الدواب لجلب حاجة العائلة من الماء صحبة الجد الذي لا يكف بدوره عن سرد قصص و مغامرات تشدك إلى سماعها فتنتابك رغبة بطلب المزيد منها، حتى أنك لا تشعر ببعد المسافة الفاصلة بين البيت و العين مصدر الماء الزلال، و بعد العودة ينهمك الجد في أشغال الفلاحة ليوفر لعياله القوت الصحي و الطبيعي، الذي يسقى بمياه الأمطار الممزوجة بعرق جبينه، بينما الجدة تعد الطعام بعد إفراغها من طهي الخبز اللذيذ و الخالي من الزوائد الكيماوية، إنها البادية و ما بها لا يوصف في كلمات و سطور، و الحنين إلى من عمروها قبلا و افتقدناهم لن تجد لهم تعويضا، لأن عالمهم الذي صنعوه بعادات و تقاليد تجمعت لتشكل ثقافة لها أسرارها و أبعادها، ترغم الأبناء و الحفدة على البحث في كنهها و التعريف بها لتبقى خالدة تتشرب بها الأجيال.

الوشم عند قبائل بني يزناسن:
بقلم محمد ستي
ظاهرة الوشم من الطقوس التي تجدرت في المجتمع الأمازيغي، و اتخذت حيزا مهما في ثقافتهم التي أبت إلا أن تثبت كينونتها، حتى أصبحت لها ضوابط تقننها، و شعائر تمارس أثناء وشم الفتاة في احتفالية تليق بالحدث، لما له من أهمية في حياة المحتفى بها، لأنه يشكل مرحلة فاصلة في حياتها، ينقلها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج، لما فيه من اعتراف صريح بقدرتها على تدبير حياة أسرة، و قد تتعداها أحيانا إلى تحمل مسؤولية قبيلة، بعد أن تكون قد راكمت تجارب عريقة مع تعاقب الأيام و السنين، فالوشم يبقى علامة بارزة توحي بجاهزية الموشومة للزواج، ولما كان التواصل محظورا بين الجنسين فلم يجدوا للعينين بديلا لهما لإحداث اتصال عاطفي، مما حدا بالوشم أن يكون السبيل الأوحد لإظهار مواطن الجمال التي تحرك لوعة الناظر إليها حتى لا يتردد في طلبها للزواج، فكان ذلك يشعرها بالزهو و انتشاء سعادة و فخر بما تحمله من رموز نقشت بإبداع على أطراف جسدها، لتكون لسان حالها بما لا تقدر على البوح به، فتأتي الرموز عبارة عن حروف تافيناغ، أو أشكال هندسية متنوعة، أو رسومات مستوحاة من الطبيعة، تتولى إحدى العجائز في المجتمع اليزناسني رسمها بإتقان على الجلد، تقصدها نساء الدوار محملة بلوازم الزيارة من سكر و حناء، و بعض ما يَجُدن به من أشياء أخرى تخص المناسبة، تحضرها بعض القريبات و الجارات للمشاركة في طقوس الوشم و مراقبة العملية، بتقديم النصح في اختيار الرسم الذي يتناسب و بشرتها لتزيده سحرا و بهاء، و الدعاء للموشومة بإحلال البركة و التمتع بالسعادة في حياتها، فرغم الألم الذي يحدثه الوشم فإنه لم يخلُ من بعض الأهازيج الخاصة للتعبير عن الفرحة بالموشومة التي صارت مؤهلة للزواج، و من أجل إبراز مواطن جمالها و جعلها أكثر انجذابا ليفتتن بها الرجال، فإنها تفضل وضع الرسم في أطراف معينة من جسدها، غالبا ما يكون على الوجه و اليدين، باعتبارهما أماكن مثيرة تسترعي انتباه الرجال، فاستحبته النساء و جعلت منه وسيلة للزينة، كما هو رسم يستدل به أيضا على الانتماء للقبيلة التي تختص بوشم يميزها عن باقي القبائل الأخرى، لذلك أسندت مهمة نقش الخطوط على الجلد لواشمة متفقهة في الرسم و التخطيط بإتقان، ليكون بطاقة هوية تثبت الانتماء بشكل جلي، و علامة إستعراضية للموشومات المؤهلات للزواج، و استعدادهن للارتباط بأبناء القبيلة دون غيرهم درءا لكل اختلاط، لم يقتصر الوشم على التجميل فقط، بل تعداه ليقوم بوظيفة علاجية مستنبطة من عمق التاريخ، في التعاطي مع الأمراض النفسية، و معاناتها المستقاة من خشونة الطبيعة و وعورتها، فكان لإخراج الدم من الجلد طرد للأرواح الشريرة التي تتلبس الإنسان، خاصة عندما يرافقها ذبح قربان مهداة لها لترتوي دما تعشقه، فتكون سببا يُطهر الجسد منها، كما تُؤدّى طقوس خاصة تكون عبارة عن ترانيم و أدعية، تحرك النفس المريضة في تجاوبها مع تلك الأجواء التي يقصد بها العلاج، على أن تنتهي بسكون مطبق يعتري على إثرها وجوم من المؤثثين لهذه الوضعية العلاجية، في انتظار ما تؤول إليه من نتائج، تُنقش الوشوم الطاردة للأرواح في أماكن خفية من الجسد، على الحنجرة و الصدر و البطن، تكون عبارة عن طلاسم صعبة الإدراك، في محاولة لتنقية الذات عندما يخترق الوشم جلد الممسوس بتلك الأرواح، كما كان له أغراض طبية بحتة يُعتقد أنها تُداوي الأمراض العضوية، فجعلت منه شفاء لكل الأسقام، فكان الخط فوق العين لتقوية البصر، و على جانبي الجبهة لتسكين آلام الرأس، ممارسات يتطلب إنجازها خبرة مشبعة بتجارب عريقة في هذا المضمار حتى لا تكون نتائجها عكسية، في حين كان الوشم يستعمل كذلك درءا للحسد و وقاية من العين، و استعمالات أخرى ذات أبعاد روحية نفسية، لكن مع التحولات التي جلبتها تعاقب الحضارات، و الاحتكاك الثقافي مع مختلف الأجناس، جعلت طقوس الوشم و ما يلفها من معتقدات التصقت بها منذ عهدها الأول تختفي تدريجيا، إلى أن أصبح الوشم يقتصر على الزينة فقط، لكن إنجازه بمهارة و إبداع يتطلب أدوات تساعد على ضبط الخط و الرسم، و إبراز فنيات النقش، و إن كانت بدائية لكنها تفي بالمطلوب رغم ما تخلفه من جروح متورمة و ملتهبة، إلا أنها سرعان ما تندمل تاركة وشما جميلا تغنى به الشعراء و استلهم منه الفنانون لواحتهم، و كان مادة دسمة للدارسين الأنتروبولوجيين، و لا زال في جعبته الكثير من الألغاز التي تحتاج إلى فك شفرتها، خاصة ما يتعلق بتلك الرموز التي لم توضع عبثا من أجل الزينة أو العلاج فقط، بل تحمل رسائل متنوعة لها معانيها و دلالتها العميقة، اجتهد الدارسون في تقديم تفسيرات و استنتاجات لبواطنها، إلا أنهم لم يستطيعوا إجلاء الغموض الذي تلبسها، لارتباطها بالذات و ما تترجمه من معتقدات و أفكار يتم إسقاطها على أماكن مختلفة من الجسد على شكل رموز ناطقة، فعلامة( +) التي تعني التاء في الأمازيغية، و هو الحرف الأول الذي تتركب منه كلمة" تامطوث"، أي المرأة المكتملة النضج، و القادرة على تحمل المسؤلية داخل الأسرة أو القبيلة، و كذلك الوشم على النهدين يرمز إلى الخصوبة و استعداد الموشومة للزواج، بينما يدل رسم المربع في العنق على الاستقرار في بيت الزوجية، أما وضع النقطة بجانب الأنف ففيه حماية من أمراض الأسنان، و رسمها بجانب العين وقاية لها مما قد تصيبها من ضعف الرؤيا أو العمى، لكن الوشوم التي توضع على الصدر و البطن و الأرداف يقصد بها كبح الرغبة الجنسية عند الفتاة إلى أن يتم لها الزواج.
الوشم عند قبائل بني يزناسن لم يبتعد كثيرا عن الطابع العام للطقوس التي تشترك فيها مع باقي الأمازيغ، باستثناء بعض الاختلافات المرتبطة بالمحيط الاجتماعي و التأثير الديني اللذان يشكلان الموجه الأساسي للفكر و المعتقد، فتظهر بصماته جليا على الرسومات التي تحتل الجسد، و لما كان فنّ الوشم لم يصل بعد إلى النساء اليزناسنيات، فقد كانت تفد عليهن بين حين و آخر جزائرية متضلعة في رسم خطوط الوشم، يجتمع عليها فتيات في مقتبل العمر لتهم بوشمهن بأدوات بدائية، تتنوع بين الكحل للوجيهات المحظوظات، و بين رماد الفرن الترابي و الفحم الأسود للطبقات الدونية، يستعمل في ثقب الجلد حسب الدارجة المحلية" شوك الهندية أو بوشوك"، لتضع الصبغ داخل الجروح حسب الاختيار حتى تبقى خالدة لا تزول، تمر هذه العملية في جو احتفالي ممزوج بالفرحة و الألم من غرز" الشوك"، الوشم لم يكن مجانا بل كانت الواشمة تستخلص مستحقاتها مُدَّي قمح أو زرع و بعضا من المال حسب المتوفر، على أن تتمرس نساء بني يزناسن على ممارسته فيما بعد، لتصبح لكل قبيلة واشمة خاصة بها، و رموز متفردة بها تضفي جاذبية على صاحبته.
و لما أصبح البعد الزيني طاغيا افتقد الوشم برموزه التي شقت الجلد وجوده الذي كان يكتسي معنى الهوية و الانتماء، و التعبير عن الذات بما يخالجها من أفكار و معتقدات، لتشق مسلكا نحو الاندثار، فكان من نتائجه أن حل محله وشم بمفاهيم مختلفة، أكثر تحررا و نقمة على الأوضاع الاجتماعية و السياسية، و التعبير عنها برموز تجسد الرفض و التمرد على الذات و الأوضاع التي تحيطها.
بقلم محمد ستي
ظاهرة الوشم من الطقوس التي تجدرت في المجتمع الأمازيغي، و اتخذت حيزا مهما في ثقافتهم التي أبت إلا أن تثبت كينونتها، حتى أصبحت لها ضوابط تقننها، و شعائر تمارس أثناء وشم الفتاة في احتفالية تليق بالحدث، لما له من أهمية في حياة المحتفى بها، لأنه يشكل مرحلة فاصلة في حياتها، ينقلها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج، لما فيه من اعتراف صريح بقدرتها على تدبير حياة أسرة، و قد تتعداها أحيانا إلى تحمل مسؤولية قبيلة، بعد أن تكون قد راكمت تجارب عريقة مع تعاقب الأيام و السنين، فالوشم يبقى علامة بارزة توحي بجاهزية الموشومة للزواج، ولما كان التواصل محظورا بين الجنسين فلم يجدوا للعينين بديلا لهما لإحداث اتصال عاطفي، مما حدا بالوشم أن يكون السبيل الأوحد لإظهار مواطن الجمال التي تحرك لوعة الناظر إليها حتى لا يتردد في طلبها للزواج، فكان ذلك يشعرها بالزهو و انتشاء سعادة و فخر بما تحمله من رموز نقشت بإبداع على أطراف جسدها، لتكون لسان حالها بما لا تقدر على البوح به، فتأتي الرموز عبارة عن حروف تافيناغ، أو أشكال هندسية متنوعة، أو رسومات مستوحاة من الطبيعة، تتولى إحدى العجائز في المجتمع اليزناسني رسمها بإتقان على الجلد، تقصدها نساء الدوار محملة بلوازم الزيارة من سكر و حناء، و بعض ما يَجُدن به من أشياء أخرى تخص المناسبة، تحضرها بعض القريبات و الجارات للمشاركة في طقوس الوشم و مراقبة العملية، بتقديم النصح في اختيار الرسم الذي يتناسب و بشرتها لتزيده سحرا و بهاء، و الدعاء للموشومة بإحلال البركة و التمتع بالسعادة في حياتها، فرغم الألم الذي يحدثه الوشم فإنه لم يخلُ من بعض الأهازيج الخاصة للتعبير عن الفرحة بالموشومة التي صارت مؤهلة للزواج، و من أجل إبراز مواطن جمالها و جعلها أكثر انجذابا ليفتتن بها الرجال، فإنها تفضل وضع الرسم في أطراف معينة من جسدها، غالبا ما يكون على الوجه و اليدين، باعتبارهما أماكن مثيرة تسترعي انتباه الرجال، فاستحبته النساء و جعلت منه وسيلة للزينة، كما هو رسم يستدل به أيضا على الانتماء للقبيلة التي تختص بوشم يميزها عن باقي القبائل الأخرى، لذلك أسندت مهمة نقش الخطوط على الجلد لواشمة متفقهة في الرسم و التخطيط بإتقان، ليكون بطاقة هوية تثبت الانتماء بشكل جلي، و علامة إستعراضية للموشومات المؤهلات للزواج، و استعدادهن للارتباط بأبناء القبيلة دون غيرهم درءا لكل اختلاط، لم يقتصر الوشم على التجميل فقط، بل تعداه ليقوم بوظيفة علاجية مستنبطة من عمق التاريخ، في التعاطي مع الأمراض النفسية، و معاناتها المستقاة من خشونة الطبيعة و وعورتها، فكان لإخراج الدم من الجلد طرد للأرواح الشريرة التي تتلبس الإنسان، خاصة عندما يرافقها ذبح قربان مهداة لها لترتوي دما تعشقه، فتكون سببا يُطهر الجسد منها، كما تُؤدّى طقوس خاصة تكون عبارة عن ترانيم و أدعية، تحرك النفس المريضة في تجاوبها مع تلك الأجواء التي يقصد بها العلاج، على أن تنتهي بسكون مطبق يعتري على إثرها وجوم من المؤثثين لهذه الوضعية العلاجية، في انتظار ما تؤول إليه من نتائج، تُنقش الوشوم الطاردة للأرواح في أماكن خفية من الجسد، على الحنجرة و الصدر و البطن، تكون عبارة عن طلاسم صعبة الإدراك، في محاولة لتنقية الذات عندما يخترق الوشم جلد الممسوس بتلك الأرواح، كما كان له أغراض طبية بحتة يُعتقد أنها تُداوي الأمراض العضوية، فجعلت منه شفاء لكل الأسقام، فكان الخط فوق العين لتقوية البصر، و على جانبي الجبهة لتسكين آلام الرأس، ممارسات يتطلب إنجازها خبرة مشبعة بتجارب عريقة في هذا المضمار حتى لا تكون نتائجها عكسية، في حين كان الوشم يستعمل كذلك درءا للحسد و وقاية من العين، و استعمالات أخرى ذات أبعاد روحية نفسية، لكن مع التحولات التي جلبتها تعاقب الحضارات، و الاحتكاك الثقافي مع مختلف الأجناس، جعلت طقوس الوشم و ما يلفها من معتقدات التصقت بها منذ عهدها الأول تختفي تدريجيا، إلى أن أصبح الوشم يقتصر على الزينة فقط، لكن إنجازه بمهارة و إبداع يتطلب أدوات تساعد على ضبط الخط و الرسم، و إبراز فنيات النقش، و إن كانت بدائية لكنها تفي بالمطلوب رغم ما تخلفه من جروح متورمة و ملتهبة، إلا أنها سرعان ما تندمل تاركة وشما جميلا تغنى به الشعراء و استلهم منه الفنانون لواحتهم، و كان مادة دسمة للدارسين الأنتروبولوجيين، و لا زال في جعبته الكثير من الألغاز التي تحتاج إلى فك شفرتها، خاصة ما يتعلق بتلك الرموز التي لم توضع عبثا من أجل الزينة أو العلاج فقط، بل تحمل رسائل متنوعة لها معانيها و دلالتها العميقة، اجتهد الدارسون في تقديم تفسيرات و استنتاجات لبواطنها، إلا أنهم لم يستطيعوا إجلاء الغموض الذي تلبسها، لارتباطها بالذات و ما تترجمه من معتقدات و أفكار يتم إسقاطها على أماكن مختلفة من الجسد على شكل رموز ناطقة، فعلامة( +) التي تعني التاء في الأمازيغية، و هو الحرف الأول الذي تتركب منه كلمة" تامطوث"، أي المرأة المكتملة النضج، و القادرة على تحمل المسؤلية داخل الأسرة أو القبيلة، و كذلك الوشم على النهدين يرمز إلى الخصوبة و استعداد الموشومة للزواج، بينما يدل رسم المربع في العنق على الاستقرار في بيت الزوجية، أما وضع النقطة بجانب الأنف ففيه حماية من أمراض الأسنان، و رسمها بجانب العين وقاية لها مما قد تصيبها من ضعف الرؤيا أو العمى، لكن الوشوم التي توضع على الصدر و البطن و الأرداف يقصد بها كبح الرغبة الجنسية عند الفتاة إلى أن يتم لها الزواج.
الوشم عند قبائل بني يزناسن لم يبتعد كثيرا عن الطابع العام للطقوس التي تشترك فيها مع باقي الأمازيغ، باستثناء بعض الاختلافات المرتبطة بالمحيط الاجتماعي و التأثير الديني اللذان يشكلان الموجه الأساسي للفكر و المعتقد، فتظهر بصماته جليا على الرسومات التي تحتل الجسد، و لما كان فنّ الوشم لم يصل بعد إلى النساء اليزناسنيات، فقد كانت تفد عليهن بين حين و آخر جزائرية متضلعة في رسم خطوط الوشم، يجتمع عليها فتيات في مقتبل العمر لتهم بوشمهن بأدوات بدائية، تتنوع بين الكحل للوجيهات المحظوظات، و بين رماد الفرن الترابي و الفحم الأسود للطبقات الدونية، يستعمل في ثقب الجلد حسب الدارجة المحلية" شوك الهندية أو بوشوك"، لتضع الصبغ داخل الجروح حسب الاختيار حتى تبقى خالدة لا تزول، تمر هذه العملية في جو احتفالي ممزوج بالفرحة و الألم من غرز" الشوك"، الوشم لم يكن مجانا بل كانت الواشمة تستخلص مستحقاتها مُدَّي قمح أو زرع و بعضا من المال حسب المتوفر، على أن تتمرس نساء بني يزناسن على ممارسته فيما بعد، لتصبح لكل قبيلة واشمة خاصة بها، و رموز متفردة بها تضفي جاذبية على صاحبته.
و لما أصبح البعد الزيني طاغيا افتقد الوشم برموزه التي شقت الجلد وجوده الذي كان يكتسي معنى الهوية و الانتماء، و التعبير عن الذات بما يخالجها من أفكار و معتقدات، لتشق مسلكا نحو الاندثار، فكان من نتائجه أن حل محله وشم بمفاهيم مختلفة، أكثر تحررا و نقمة على الأوضاع الاجتماعية و السياسية، و التعبير عنها برموز تجسد الرفض و التمرد على الذات و الأوضاع التي تحيطها.